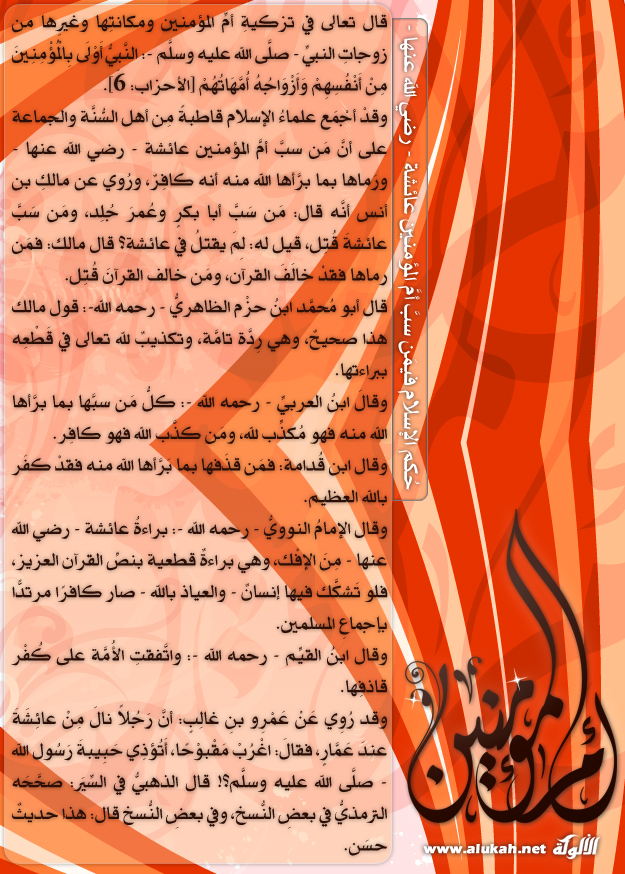"من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل، ويحترم منطقه، ويبنى الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق. .
والتوافق بين صريح المعقول وصحيح المنقول أمرٌ مقرر في ثقافتنا التقليدية على اختلاف مدارسها. وكما يقول العقاد: التفكير فريضة إسلامية...
ودعوة القرآن الكريم إلى النظر مطلقة لا يحدها حدٌّ
والتوافق بين صريح المعقول وصحيح المنقول أمرٌ مقرر في ثقافتنا التقليدية على اختلاف مدارسها. وكما يقول العقاد: التفكير فريضة إسلامية...
ودعوة القرآن الكريم إلى النظر مطلقة لا يحدها حدٌّ
ما دام ذلك النظر ممكناً، وما دام يؤدي إلى نتيجة صحيحة: ( أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء). إن دائرة النظر رحبة تستوعب كل شيء ولا قيد عليها إلا ما ينفي الخطأ ويضمن اليقين. .
كان يستلفتني وأنا أدْبّر القرآن ـ هذا التعانق بين الفكر والشعور أو بين العقل والعاطفة أو بين الإيمان والسلوك!
خذ مثلاً هذه الآية الكريمة: (ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليُريَكم من آياته إنّ في ذلك لآياتٍ لكل صبّار شَكور). وهذه سفن تشق عباب الموج حاملة أثقالاً من السلع والمعادن والمُؤن ينتظرها الناسُ من شاطئ إلى شاطئ، ألا يحتفل بهذا الفضل؟ ألا يشكر سائق هذه النعماء؟ ألا يورث ذلك إيماناً حسناً يلقي السراء بالشكر والضراء بالصبر؟
إنّ سَير السفن في الماء، أو في الهواء، حافلة بالقناطير المقنطرة من الخيرات التي كرّم الله بها بني آدم، شيءٌ يدل على القدرة العليا أولاً، وعلى الفضل الأعلى أخيراً، فلِمَ لا يكترث الناس لذلك ويعرفون صاحبه ويستكينون لحكمه ويُحسنون الإيمان؟
وقد أحصيت في القرآن الكريم "أولي الألباب" فوجدتها تكررت خمسَ عشْرةَ مرةً. وأولو الألباب هم أصحاب العقول، كأن العقل هو لُب المرء وما عداه قِشر . .
ولسنا هنا بصدد شرح الكلمة في المواطن التي جاءت فيها، ولكننا ننبه إلى أمر خطير: أن العقل مناط التكليف، وأن الذكاء أساس الوعي، وأن الدين لا يكمل مع القصور في العقل والقِلة في الذكاء، وأنه لابد من ملكات إنسانية رفيعة لكي تعرف الله وهديه، وتفقه توجيهه ووحيه.
وأن الهمل قد يسقطون دون مستوى الخطاب، وأن الشعوب البلهاء قد تشد الدين نفسه إلى أسفل، بدل أن يصعد بها إلى أعلى! وهنا الطامّة. .!
العقل أثمن ما وهبه الله لعباده وهو لا يولد تاماً ناضجاً، وإنما يتم وينضَج بوسائل شتى تعالج بها معادن الرجال والنساء، فإذا لم تتوافرْ تلك الوسائلُ كان التخلفُ والقصور، واختفى أو ندر أولو الألباب الذين يقدِرون على الإفادة من الدين . .!!
نعم إن الإزراء على الدين كثيراً ما يقع لسوء الحكم ـ أعني الاستنتاج ـ أو لعِوَج الفهم، وذاك ما جعل أبا العلاء يتشاءم ويغرق عندما يقول:
اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دِين وآخَرُ ديّنٌ لاعقل له
ويحزنني أن أذكر هنا أنّ أعداداً كثيفة من المنتمين إلى الدين فقيرة إلى سَعة الإدراك والنفاذ إلى الأعماق، وعمل هؤلاء في ميادين الدعوة يضرّ أكثرَ مما ينفع. .
وقد أجمعت الأمم على أن تصحيح العقل وترشيد حكمه لابد فيه من مراحل تعليمية ابتدائية ومتوسطة وعالية قد تستغرق بضعة عشر عاماً. .
ثم إن المعارف المستفادة صنوفٌ شتى، فهناك علوم الكون والحياة، وأسرة العلوم الرياضية، وأسرة العلوم الإنسانية. .
والمسلم إنسان يضم إلى معرفة كل نافع من شؤون الدنيا معرفة أخرى جليلة القدر غزيرة الأجر: كتاب ربه وهدي نبيه. .
وهذا النوع من الثقافة الدينية يصور فلسفته في الحياة ومنهجه الفذ بين المناهج التي اختطتها الجماهير. .
وعندي أن علماء الإسلام يجب أن تكون لهم أقدارٌ راسخة في كل مجالات المعرفة، وأن تكون إحاطتهم بالمذاهب الجائرة أكثرَ من إحاطة أهلها. .
ومنزلة علوم الكون والحياة في إنجاح الجهاد الإسلامي لا ريب فيها، ومن أجل ذلك فإن التفوق فيها أولى من معرفة فروع شتى في فِقه العبادات والمعاملات! إن صيانة الأصل أرجح وأهم. .
وهناك أنواع من العلم ليس أحد أولى بها من أحد، لماذا نتركها لغيرنا ولا نجود نحن فيها أو ننقلها إلى ربوعنا؟
إنه لا حرج على المسلمين لو ساحوا في أرجاء القارات، واطلعوا على أحوال الخلائق وراقبوا أحوال الشعوب والحكومات، ثم انتقوا مما يرون الأساليب الإدارية والنظم الحضارية التي تخدم مثلهم وتحقق أهدافهم. . .
وأرى أن ذلك أوجب بعدما تعفنت الأوضاع السياسية والاقتصادية لدينا في عصور الجمود والتخلف.
تلك العصور التي غلبت على تاريخنا وأوهنت كياننا ثم أسقطت خلافتنا ومزقتنا كل ممزق.
مصارحة:
وأجدني قد بلغت في الحديث مرحلة توجب المصارحة، فإن النفاق في محاسبة النفس لا يُحدِث توبة للفرد ولا نهضة للجماعة!
لقد سلخ الإسلام من عمره المديد أربعة عشَر قرناً، وبلغ مرحلة في يومه هذا توجب على أولي الألباب أن يتوقفوا ويتساءلوا: ماذا عرانا؟ وكيف الخلاص؟
أجل، ما الأحوال داخل دار الإسلام، ووراء حدودها المترامية بعد هذه الرحلة الشاقة؟
إننا نوقن أننا على حق! الله واحد لا شريك له! أين هذا الشريك إن وجد؟
محمد حق! إنه على قمم البشرية طيبة النفس، وإشراق عباده، وسناء خلق، ونزاهة وجهاد!
وإذا لم يكن محمد رسولاً يجيد تعريف الناس بربهم واقتيادهم إليه بالأُسوة الحسنة فمن ـ من الأولين والآخرين ـ يصلح لاصطفاء السماء وإمامة الخلائق؟!
إن المغلفين الذين خدعتهم أجهزة الزور يحسبون أننا نتبع محمداً على تقليد ساذج!
إنّ بقاءَنا على الإسلام هو تقديرنا للحقيقة مهما أحاط بها من ملابسات رديئة. . .
والآن بعد هذا التوكيد لصلتنا بديننا أسأل نفسي وقومي: هل كنا أوفياء لهذا الدين خلال العصور الماضية؟ هل كنا عند أمره ونهيه عندما جاءت القرون الأخيرة، فإذا قوى الشر تجتاح الحدود وتستبيح البيضة وتقتحم عقر الدار. .؟
لقد كان النظام الإسلامي أشبه بسكران يترنح ذات اليمين وذات اليسار، يسقط حيناً ثم يقوم من الوحل معفّراً بالأقذار، فلا يتقدم خطوة إلا تراجع خطوات،مثيراً للضحك حيناً وللاشمئزاز أحيانا. .!
ما عملنا بديننا في الداخل، ولا شرفنا سمعته أو دعونا إليه في الخارج!
ويجيء سؤالٌ آخَر: ماذا كانت عليه أحوال غيرنا؟
لقد انطلق وراء عقله يشق الطريق ببأس شديد، ويحطم الخرافات الدينية التي آذته دهرا، وثابر على أعباء الرقى حتى بلغ في خمسة قرون مكانة غزا فيها الفضاء بعدما كاد يملك ناصية الأرض!
وجاءته النصرانية معتذرة عن موقفها منه وعرضت عليه خِدْماتها، فقبل العذر، وصالحها على خدمة هواه.
وواجهنا نحن موقفاً شديدَ التعقيد، كنا في السفح وهو في القِمة، كانت طاعتنا لله تتمثل في عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو في عبادات تافهة كبرناها ألف مرة عن حجمها الحقيقي لتملأ الفراغ النفسي والاجتماعي الناشئ عن غيبة الدين الحق. .! فلما تلاقى الجمعان صِرنا هباءً وصرنا سُدىً!!
إننا ـ نحن المسلمين والعرب ـ خُنّا ديننا خيانة فاحشة، فلم نحسر النظر في شئ مع صراخ الوحي حولنا (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء)؟
وكانت النتيجة أن جاء من وراء الحدود ـ حدود دار الإسلام ـ من استخرج النفط من أرضنا، ومن أقام الجسور على أنهارنا، ومن صنع لنا حتى الإبرة التي نخيط بها ملابسنا...
ما كنا نحسن من شؤون الدنيا شيئاً نسديه لأنفسنا أو ندعم به إيماننا!
ولنترك ذلك، فإن أحداً لا يكابر في هذا التخلف، ولا في ضرورة الإفادة العملية ممن سبقونا في آفاق الحضارة المنتصرة.
وننتقل إلى ميدان آخر. . لقد جأرت بالشكوى في هذا الكتاب وفي كتب أخرى من تخلفنا الفقهي والعملي في الشئون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن انحسار الفقه الإسلامي داخل حدود ضيقة إن تجاوزت بيوت الماء، فإلى ساحة المسجد، وقد تتدخل في شؤون الحارة أو القرية . . أما دواوين السلطة، ومشكلات المال، ومفاصل الحياة الحقيقية للمجتمع والدولة، فإن الفقه لا علاقة له بها ونتج عن ذلك أن الاستبداد السياسي عربد دون حذر، وأن الخلل الاقتصادي شاع دون علاج.
وأن الأعصاب التي تشد الكيان الإسلامي استرخت ثن انقطعت، وتاه المسلمون بعضهم عن بعض.
وأن الشخصية المعنوية للأمة الإسلامية ولرسالتها الكبرى تلاشت في طوال الدنيا وعرضها ".
كان يستلفتني وأنا أدْبّر القرآن ـ هذا التعانق بين الفكر والشعور أو بين العقل والعاطفة أو بين الإيمان والسلوك!
خذ مثلاً هذه الآية الكريمة: (ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليُريَكم من آياته إنّ في ذلك لآياتٍ لكل صبّار شَكور). وهذه سفن تشق عباب الموج حاملة أثقالاً من السلع والمعادن والمُؤن ينتظرها الناسُ من شاطئ إلى شاطئ، ألا يحتفل بهذا الفضل؟ ألا يشكر سائق هذه النعماء؟ ألا يورث ذلك إيماناً حسناً يلقي السراء بالشكر والضراء بالصبر؟
إنّ سَير السفن في الماء، أو في الهواء، حافلة بالقناطير المقنطرة من الخيرات التي كرّم الله بها بني آدم، شيءٌ يدل على القدرة العليا أولاً، وعلى الفضل الأعلى أخيراً، فلِمَ لا يكترث الناس لذلك ويعرفون صاحبه ويستكينون لحكمه ويُحسنون الإيمان؟
وقد أحصيت في القرآن الكريم "أولي الألباب" فوجدتها تكررت خمسَ عشْرةَ مرةً. وأولو الألباب هم أصحاب العقول، كأن العقل هو لُب المرء وما عداه قِشر . .
ولسنا هنا بصدد شرح الكلمة في المواطن التي جاءت فيها، ولكننا ننبه إلى أمر خطير: أن العقل مناط التكليف، وأن الذكاء أساس الوعي، وأن الدين لا يكمل مع القصور في العقل والقِلة في الذكاء، وأنه لابد من ملكات إنسانية رفيعة لكي تعرف الله وهديه، وتفقه توجيهه ووحيه.
وأن الهمل قد يسقطون دون مستوى الخطاب، وأن الشعوب البلهاء قد تشد الدين نفسه إلى أسفل، بدل أن يصعد بها إلى أعلى! وهنا الطامّة. .!
العقل أثمن ما وهبه الله لعباده وهو لا يولد تاماً ناضجاً، وإنما يتم وينضَج بوسائل شتى تعالج بها معادن الرجال والنساء، فإذا لم تتوافرْ تلك الوسائلُ كان التخلفُ والقصور، واختفى أو ندر أولو الألباب الذين يقدِرون على الإفادة من الدين . .!!
نعم إن الإزراء على الدين كثيراً ما يقع لسوء الحكم ـ أعني الاستنتاج ـ أو لعِوَج الفهم، وذاك ما جعل أبا العلاء يتشاءم ويغرق عندما يقول:
اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دِين وآخَرُ ديّنٌ لاعقل له
ويحزنني أن أذكر هنا أنّ أعداداً كثيفة من المنتمين إلى الدين فقيرة إلى سَعة الإدراك والنفاذ إلى الأعماق، وعمل هؤلاء في ميادين الدعوة يضرّ أكثرَ مما ينفع. .
وقد أجمعت الأمم على أن تصحيح العقل وترشيد حكمه لابد فيه من مراحل تعليمية ابتدائية ومتوسطة وعالية قد تستغرق بضعة عشر عاماً. .
ثم إن المعارف المستفادة صنوفٌ شتى، فهناك علوم الكون والحياة، وأسرة العلوم الرياضية، وأسرة العلوم الإنسانية. .
والمسلم إنسان يضم إلى معرفة كل نافع من شؤون الدنيا معرفة أخرى جليلة القدر غزيرة الأجر: كتاب ربه وهدي نبيه. .
وهذا النوع من الثقافة الدينية يصور فلسفته في الحياة ومنهجه الفذ بين المناهج التي اختطتها الجماهير. .
وعندي أن علماء الإسلام يجب أن تكون لهم أقدارٌ راسخة في كل مجالات المعرفة، وأن تكون إحاطتهم بالمذاهب الجائرة أكثرَ من إحاطة أهلها. .
ومنزلة علوم الكون والحياة في إنجاح الجهاد الإسلامي لا ريب فيها، ومن أجل ذلك فإن التفوق فيها أولى من معرفة فروع شتى في فِقه العبادات والمعاملات! إن صيانة الأصل أرجح وأهم. .
وهناك أنواع من العلم ليس أحد أولى بها من أحد، لماذا نتركها لغيرنا ولا نجود نحن فيها أو ننقلها إلى ربوعنا؟
إنه لا حرج على المسلمين لو ساحوا في أرجاء القارات، واطلعوا على أحوال الخلائق وراقبوا أحوال الشعوب والحكومات، ثم انتقوا مما يرون الأساليب الإدارية والنظم الحضارية التي تخدم مثلهم وتحقق أهدافهم. . .
وأرى أن ذلك أوجب بعدما تعفنت الأوضاع السياسية والاقتصادية لدينا في عصور الجمود والتخلف.
تلك العصور التي غلبت على تاريخنا وأوهنت كياننا ثم أسقطت خلافتنا ومزقتنا كل ممزق.
مصارحة:
وأجدني قد بلغت في الحديث مرحلة توجب المصارحة، فإن النفاق في محاسبة النفس لا يُحدِث توبة للفرد ولا نهضة للجماعة!
لقد سلخ الإسلام من عمره المديد أربعة عشَر قرناً، وبلغ مرحلة في يومه هذا توجب على أولي الألباب أن يتوقفوا ويتساءلوا: ماذا عرانا؟ وكيف الخلاص؟
أجل، ما الأحوال داخل دار الإسلام، ووراء حدودها المترامية بعد هذه الرحلة الشاقة؟
إننا نوقن أننا على حق! الله واحد لا شريك له! أين هذا الشريك إن وجد؟
محمد حق! إنه على قمم البشرية طيبة النفس، وإشراق عباده، وسناء خلق، ونزاهة وجهاد!
وإذا لم يكن محمد رسولاً يجيد تعريف الناس بربهم واقتيادهم إليه بالأُسوة الحسنة فمن ـ من الأولين والآخرين ـ يصلح لاصطفاء السماء وإمامة الخلائق؟!
إن المغلفين الذين خدعتهم أجهزة الزور يحسبون أننا نتبع محمداً على تقليد ساذج!
إنّ بقاءَنا على الإسلام هو تقديرنا للحقيقة مهما أحاط بها من ملابسات رديئة. . .
والآن بعد هذا التوكيد لصلتنا بديننا أسأل نفسي وقومي: هل كنا أوفياء لهذا الدين خلال العصور الماضية؟ هل كنا عند أمره ونهيه عندما جاءت القرون الأخيرة، فإذا قوى الشر تجتاح الحدود وتستبيح البيضة وتقتحم عقر الدار. .؟
لقد كان النظام الإسلامي أشبه بسكران يترنح ذات اليمين وذات اليسار، يسقط حيناً ثم يقوم من الوحل معفّراً بالأقذار، فلا يتقدم خطوة إلا تراجع خطوات،مثيراً للضحك حيناً وللاشمئزاز أحيانا. .!
ما عملنا بديننا في الداخل، ولا شرفنا سمعته أو دعونا إليه في الخارج!
ويجيء سؤالٌ آخَر: ماذا كانت عليه أحوال غيرنا؟
لقد انطلق وراء عقله يشق الطريق ببأس شديد، ويحطم الخرافات الدينية التي آذته دهرا، وثابر على أعباء الرقى حتى بلغ في خمسة قرون مكانة غزا فيها الفضاء بعدما كاد يملك ناصية الأرض!
وجاءته النصرانية معتذرة عن موقفها منه وعرضت عليه خِدْماتها، فقبل العذر، وصالحها على خدمة هواه.
وواجهنا نحن موقفاً شديدَ التعقيد، كنا في السفح وهو في القِمة، كانت طاعتنا لله تتمثل في عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو في عبادات تافهة كبرناها ألف مرة عن حجمها الحقيقي لتملأ الفراغ النفسي والاجتماعي الناشئ عن غيبة الدين الحق. .! فلما تلاقى الجمعان صِرنا هباءً وصرنا سُدىً!!
إننا ـ نحن المسلمين والعرب ـ خُنّا ديننا خيانة فاحشة، فلم نحسر النظر في شئ مع صراخ الوحي حولنا (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء)؟
وكانت النتيجة أن جاء من وراء الحدود ـ حدود دار الإسلام ـ من استخرج النفط من أرضنا، ومن أقام الجسور على أنهارنا، ومن صنع لنا حتى الإبرة التي نخيط بها ملابسنا...
ما كنا نحسن من شؤون الدنيا شيئاً نسديه لأنفسنا أو ندعم به إيماننا!
ولنترك ذلك، فإن أحداً لا يكابر في هذا التخلف، ولا في ضرورة الإفادة العملية ممن سبقونا في آفاق الحضارة المنتصرة.
وننتقل إلى ميدان آخر. . لقد جأرت بالشكوى في هذا الكتاب وفي كتب أخرى من تخلفنا الفقهي والعملي في الشئون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن انحسار الفقه الإسلامي داخل حدود ضيقة إن تجاوزت بيوت الماء، فإلى ساحة المسجد، وقد تتدخل في شؤون الحارة أو القرية . . أما دواوين السلطة، ومشكلات المال، ومفاصل الحياة الحقيقية للمجتمع والدولة، فإن الفقه لا علاقة له بها ونتج عن ذلك أن الاستبداد السياسي عربد دون حذر، وأن الخلل الاقتصادي شاع دون علاج.
وأن الأعصاب التي تشد الكيان الإسلامي استرخت ثن انقطعت، وتاه المسلمون بعضهم عن بعض.
وأن الشخصية المعنوية للأمة الإسلامية ولرسالتها الكبرى تلاشت في طوال الدنيا وعرضها ".