|
مجلس : اللغة العربية
الوداع |      ( من قبل 2 أعضاء ) قيّم ( من قبل 2 أعضاء ) قيّم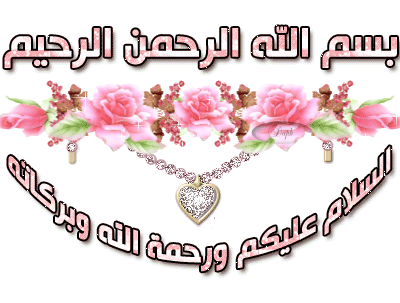 وداع من بعده لقاء قريب إن شاء الله |      ( من قبل 1 أعضاء ) قيّم ( من قبل 1 أعضاء ) قيّمعنوان تعليق شيخي يحيى المحترم: " إلا النحو" ذكرني بـ " إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم" التي حفلت بها الشبكة العنكبوتية إبان اعتديَ على شخصية الرسول الأكرم بالرسوم المسيئة، فقلت لنفسي: الرسول يبلغ رسالة من الله إلى الناس، وعلم النحو والصرف والاشتقاق وغيرها من العلوم الإنسانية رسالة من الناس إلى الناس، وتابعت قائلا: شتان* بين إلا وإلا . هذا، وإني أشكر شيخي على فضله، فتعليقاته جعلتني أسرح بناظري وبعقلي على الشبكة؛ أطالع ما تذكره في الاشتقاق اللغوي العربي ، وقد استفدت منها كثيرا، وراجعت معلومات كانت لدي منسية أو شبه منسية. إن علم النحو نظرية وضعها علماء اللغة؛ معتمدين فيها على الاستقراء والقياس. وما دامت نظرية، فهي محل للأخذ والرد، وعرضة للاتفاق في بعضها والاختلاف في بعضها الآخر بين النحاة، وعرضة لأن تساير هذا العصر وكل عصر، مثلما سايرت عصورا خلت. وهذا أمر طبيعي جدا. فاللغة كائن حي كما قالوا، والخلافات النحوية أمرها مشهور، ومدارس النحو صيتها ذائع ، وكل مدرسة خالفت الأخرى في بعض أمور هذا العلم كما هو معروف لدينا جميعا، بل إن من أصحاب المدرسة الواحدة نفسها من خالف بعضهم بعضا. المهم أن الخلاف في أية نظرية أمر جائز وواقعي، وربما يثري العلومَ الخلافُ فيها . أما اشتقاق اسم المفعول من المصدر، أو من الفعل الماضي المستند إلى المفرد الغائب، أو من الفعل المبني للمجهول كما قال شيخي، فالهدف من الاشتقاق ونتائجه هو ما يهمنا أكثر دون شك. ولقد بحثت عن " مكرور" بمعنى المُعاد مرة بعد اخرى، في مجالس الوراق، فوجدتها وقد ذكرت مرات ومرات، في التعليقات وفي المشاركات المنقولة، ولم لا؟ ألم يذكرها كعب بن زهير في شعره؟ وذكرها كذلك الطرماح، والبحتري ( والبحتري ممن التزموا عمود الشعر تماما) ذكرها ثلاث مرات، وذكرها مهيار الديلمي ، هذا، غير ما لم تصل إليه معلوماتي المتواضعة. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن هذه اللفظة التي وردت عند كعب بن زهير بن أبي سلمى يمكن الحكم ببطلانها؛ قياسا على طرق الاشتقاق التي اختلف فيها ، والتي وضعها علماء اللغة بعد كعب بمئات السنين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * في"شتان" هذه خلاف بين الأصمعي وأبي زيد النحوي. فقد قيل لأبي زيد النحوي: إن الأصمعي قال: لا يقال: شتان ما بينهما، إنما يقال: شتان ما هما، وأنشد قول الأعشى: شتان ما يومي على كورها فقال: كذب الأصمعي، يقال: شتان ما هما، وشتان ما بينهما، وأنشدني لربيعة الرقي، واحتج به: لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر ابن حاتم وفي استشهاد مثل أبي زيد على دفع مثل قول الأصمعي بشعر ربيعة الرقي، كفاية له في تفضيله. وذكره عبد الله بن المعتز فقال: كان ربيعة أشعر غزلاً من أبي نواس، لأن في غزل أبي نواس برداً كثيراً، وغزل هذا سليم سهل عذب.(الأغاني) . أقول أنا ياسين: فلننظر في الخلاف الذي ذكرناه ففيه تصديق لما قلنا آنفا. ولننظر أيضا قوله: "كذب الأصمعي" بدل أن يقول أخطأ . والظاهر أن المقصود بـ" كذب" هنا، أنه قال ما يخالف الحقيقة؛ مع أن الكذب لا يعني إلا تعمد إخفاء الحقيقة. ففرق كبير بين الخطأ والكذب . والكذب بمعنى الخطأ ورد في كتب التراث كثيرا. ولقد كان الأصمعي وأبو زيد النحوي متعاصرين، فهل كان بينهما كراهية وعداء حتى يتهم النحوي الأصمعي بالكذب المتعمد فعلا؟ الله أعلم. أضف تعليقك |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||